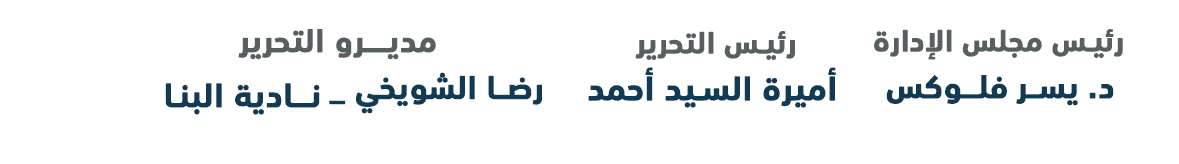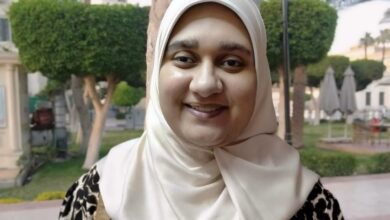روايات عربية| شقي وسعيد حسين عبد الرحيم
سلسلة عن حكايات الروايات المصرية والعربية في منصة كلمتنا

شقي وسعيد: قراءة في رواية الانقسام الوجودي
يمتلك الروائي المصري حسين عبد الرحيم في رصيده الأدبي أربع روايات، كانت بدايته مع “عربة تجرها الخيول” واختتم مسيرته حتى الآن برواية “شقي وسعيد”، التي يشكل عنوانها المدخل الأول لفهم النص بوصفه علامة على التناقض أو القلق الوجودي الذي تعج به الرواية، وكأننا أمام إنسان منشطر إلى نصفين أحدهما ظلام والآخر نور، أو أحدهما ثلج والآخر نار، أو أحدهما جبل والآخر بحر، وما إلى ذلك من ثنائيات متقابلة متضادة.
كما أنها رواية من النمط الدائري تبدأ بمشهد وفاة الأم وتختتم بنفس مشهد الوفاة، وكأنها حلقة مفرغة لا مخرج منها، الأم هي الصديقة، والابن هو الحسين، تحكم بطل الرواية علاقة أوديبية معقدة تجمعه بأمه.
يتمتع حسين عبد الرحيم بمميزات بالغة الأهمية كروائي، فقد أمضى فترة طويلة في العمل السينمائي في السينما المصرية كمساعد مخرج، ولذلك ستجده أقرب إلى كاتب سيناريو يصور المشاهد مع تقطيع مستمر للزمن الروائي كما في كل أعمال ما بعد الحداثة، إنه يحول الزمن التسلسلي إلى مجموعة من اللقطات الزمنية المتعاقبة التي تخدم كلها الفكرة التي يسعى إلى تحقيقها، إلى الحد الذي يقوم فيه بتقطيع الزمن عشر مرات في صفحة واحدة، مما يمنح النص إثارة تامة، وحتى لو كان يكرر العبارات فإنه في كل مرة يضيف لعبارته شيئا جديدا مما يكسر حدة الملل مع تدفق وصفي متلاحق يجعلك تلهث خلفه بحثا عن تلك القصة التي تجري عبر أزمنة وأمكنة مختلفة ومتباينة.
إنها رواية عن الخوف والتمرد وعن الموت والحياة وعن الصدق والكذب وكل ما تحمله الحياة من تناقض، هذا التناقض الذي يمنح في أحيان كثيرة الحياة نفسها معناها، كما أنه يمتلك لغة متدفقة كشلال، لا يتوقف عن الانتقام من كل من ترك في روح البطبع ألما ما مهما كان صغره، يتحدث حسين عبد الرحيم عن نوع من الفقر الذي تعيشه الطبقة الكادحة في المجتمع البورسعيدي في نهاية الستينيات، فبطل الرواية مواليد عام 1967، ومولده أتى بالحرب، تقول أم الطفل له في ص 11 من الرواية:
“فقري من ميلادك، جئت للحرب وللحرب جئت للشقاء بك عدنا، يا فقري، يا وجه الفقر”
لقد ولد بطل الرواية في عام الحرب في يونيو في نفس زمن الحرب 1967، والحرب تعني هجرة سكان مدن القناة إلى المنزلة ودمياط والمنصورة والقرى والنجوع وشكل مختلف تماما للحياة على شواطئ المتوسط، وغيرها من الأماكن إلى أن يعودوا مرة أخرى بعد سنوات عديدة وقد أصبحوا أناسا آخرين غير الذين خرجوا من مدن القناة بعد أن تعرضوا لكل أفاعي المدن والقرى التي مروا بها.
يبني حسين روايته على فكرة أن الذي يحكي هو الطفل المولود، وهو مفهوم على غرابته أقرب لمفهوم مقدس حين يحكي الطفل فهو يحكي الحقيقة لأنه في نظرنا يمثل البراءة، يتذكر الطفل علاقته بأمه طيلة العمل، منذ ميلاده حتى رحيلها، وكيف أن أصابعه (النونو) تلتف حول أصابع أمه متمسكا بها، ويستدعي أبوه كل بضع فقرات يصب جام غضبه عليه، وهو بين قسوة الأب وحنان الأم ممزق وضائع.
في أحد مشاهد الرواية البليغة، يتحدث بطل الرواية عن أنه رأى أمه وأبيه يجلسان في مطعم مشويات يأكلان كباب وكفته، بينما كان هو في طريقه لشراء سندوتشات فول وطعمية وقرطاسين من الكاساتا (الآيس كريم) له ولأخيه، لكن كل ذلك يقع من بين يديه في الزحام فتتسخ ملابسه وحذاءه، فيعود للمنزل وقد صعدت ثورته لتحتل جسده كله ليمسك ببلطة صغيرة منتقما من أبيه فيهشم أقفاص الخضروات والفاكهة في مشهد جنوني تماما يحكي مدى حبه لأمه وغيرته الشديدة عليها.
الرواية عبارة عن نهر متدفق من الحكي كما سلف وأشرت، لغة قاسية تنضح بالفقر المدقع والوحدة والثورة والانتقام والكراهية والحب، لغة لا تتوقف تنهمر كشلال عاتي يملأ بحيرات الغضب، فإن كنت قد قرأت لازلو كرازناهوري في لغته المتدفقة في روايته الأشهر “تانجو الشيطان” ستجد أن حسين فعل ذلك من خلال سرده التذكري، وفعل أيضا مثل هيمنجواي في لغته التي لا يكشف فيها عن نهاية الحدث إلا في الصفحة الأخيرة من الرواية ومع تقدمك في القراءة ستجد أن حسين عبد الرحيم يلعب تلك اللعبة عبر فصول روايته الصغيرة، فهو في كل مرة يعود لنفس الصور ويضع صفات جديدة تشعرك بالتقدم في العمل وأنه يضيف حقائق جديدة حول علاقته بأمه، لن أتناول بقية شخصيات الرواية فهي أشباح للأم والأب والابن.
إن نزعة حسين عبد الرحيم هنا وفي هذه الرواية في بعض مداخلاتها تشعرك بما فعله سوفوكليس في أوديب ملكا، تلك اللغة المأساوية الساخنة التي تحتوي حنق العالم كله، وتلك الحكاية التي ستتكرر أبد الزمن، وتلك اللعنة التي تصاحب بطلها في حله وترحاله، لقد أفاض الجميع في (أوديب)، فحين حاكم سوفوكليس القدر والآلهة الإغريقية التي أبت إلا تحقيق أسطورة أوديب من خلال ثلاث مسرحيات، ثم توفيق الحكيم ومحاكمته للواقع والفرق بينه وبين الخيال، أبى حسين أن يدخل هذا النفق لاعتبارات عديدة، لأنه ليس هذا الإغريقي العتيد، ولا يدعي الفلسفة وإن كان يمارسها أحيانا داخل النص.
هنا حوّل حسين عبد الرحيم الحكاية، لحكاية إنسانية خالصة، كما يأخذ الأمر منحى آخر معه لقد قال بأنه ابن الفاقة التي يتعثر في ظلالها، كما أن الرواية تجمع بين الخاص والعام، وفي الفن بشكل عام لا أحبذ الإشارة للخاص لأن هذا الخاص صدر فنا وليس سيرة ذاتية بوقائع محددة، لقد سمحنا للبلاغة والخيال والحيل الفنية بدخول الملعب، حيث تقف الرواية والقصة القصيرة والنوفيللا وغيرها من الخيال السردي، فتحولت إلى فن متاح للعالم.
يضيف حسين عبد الرحيم في كل صفحة جديدا عن مأساة الهجرة عام 1967، كيف دخل أبناء الشمال المصري إلى عمق الغابة المصرية وهناك بين المدن والقرى تولد حكايات جديدة شائكة، لكنها مصرية خالصة مثلما فعل يوسف إدريس في الحرام، مأساة أخرى من عمق القرى والكفور والنجوع، وتستمر سيرة الرواية المصرية حتى يأتي حسين ليستكمل حكايات الوجع الأسطورية فيقدم لنا دون أي ادعاءات حكايات الفقراء والهجرة إلى عوالم أخرى داخل المحروسة، حكايات الألم والوجع في (شقي وسعيد) في طبعتها الثانية.
بالطبع لا يوجد عمل كامل، لكن مهما كانت الهنات فهي لا تقلل من قيمة العمل كتأريخ لمنطقة مظلمة في التاريخ المصري الحديث، فلا تاريخ ستجده للطبقات المتوسطة والفقيرة، فيقدم حسين عبد الرحيم تأريخا سرديا قصصيا بالزمان والمكان للوقائع، ولكل ما ينتمي للأسر المصرية الفقيرة بين أعوام الشقاء 1967-1973.
لقد استمتعت بالعمل وأردت تقديم انطباعات سريعة تحاول أن تتسربل بالنقد الأدبي والثقافي، فهنيئا للرواية المصرية والعربية هذا الجديد للكاتب المصري بروايته الجديدة (شقي وسعيد).