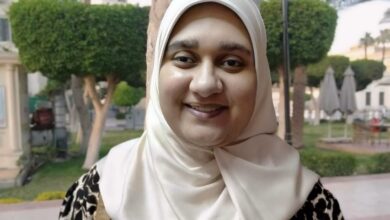كيف نستدرج الحقيقة في شوارع يحكمها كبرياء المعرفة؟
في زحام الشوارع، حيث تتلاطم الأمواج البشرية وتتشابك المصالح، يبرز تساؤل جوهري حول الطريقة التي نصل بها إلى اليقين. هل يكفي أن تسأل لتعرف؟
الواقع يخبرنا أن السؤال الصريح غالبًا ما يقابل بإجابات مقتضبة أو تجاهل متعمد، لكن ثمة مفتاح سحري يفتح الخزائن الموصدة للعقول، وهو ما يعرف بـ «قانون كانينجهام».
هذا القانون لا يتحدث عن الفيزياء أو الرياضيات، بل عن هندسة النفس البشرية التي لا تطيق رؤية خطأ يمر بسلام.
المبدأ بسيط وصادم: أفضل طريقة للحصول على الإجابة الصحيحة ليست في طرح السؤال، بل في نشر الإجابة الخاطئة.
تأمل عزيزي المشاهد المتكررة في المواصلات العامة أو المجالس الجانبية؛ شخص يلقي بمعلومة مغلوطة تمامًا حول إجراء قانوني جديد أو سعر سلعة حيوية، وبدلاً من الصمت الذي كان يغلّف المكان، تنفجر فجأة طاقات معرفية مكبوتة.
يهبّ الجالس في الزاوية، والمنشغل بهاتفه، والمتردد، كلهم يشتركون في ملحمة تصحيحية واحدة. هنا، لم تخرج الحقيقة لأنهم أرادوا المساعدة، بل لأن «غريزة التصحيح» لديهم كانت أقوى من رغبتهم في الصمت.
نحن، كبشر، نملك ميلاً فطريًا لإثبات كفاءتنا المعرفية،
وتصحيح الآخر ليس مجرد فعل تعليمي، بل هو انتصار صغير للأنا، واستعراض ضمني للقوة أمام الجمع.
يمتد هذا الإسقاط ليشمل أروقة السياسة والإدارة العامة في الشارع. ففي كثير من الأحيان، تظل المعلومات الرسمية حبيسة الأدراج، ولا تخرج للنور إلا حين تشتعل «إشاعة مستفزة» تهدد المنطق العام. هنا تضطر الجهات المسؤولة لكسر حاجز الصمت، ليس استجابة لطلبات الإحاطة الهادئة، بل دفاعًا عن الصورة الذهنية ضد الخطأ الذي انتشر.
إن الشارع لا يعطيك سره إذا وقفت في موقف المستجدي للمعلومة، بل يعطيك إياه حين تضعه في موقف المُدافع عن الحقيقة.
الحقيقة التي أصبحت في مجتمعاتنا تُستدرج ولا تُطلب، تُنتزع من أفواه الغاضبين ولا تُمنح للباحثين الهادئين.
إن هذا السلوك يكشف عن خلل وتحايل في آن واحد؛ فهو يكشف أن مخازن المعلومات لدينا لا تفتح أبوابها إلا بمفاتيح الاستفزاز.
لقد تحول الجدال في طرقاتنا من وسيلة للفهم إلى حلبة للمبارزة المعرفية، حيث يربح من يملك «التصويب الأخير».
ومن هنا، يصبح الذكاء الاجتماعي متمثلاً في القدرة على صياغة الخطأ الذكي الذي يحفز الآخرين على البوح بالصواب.
إنها لعبة مرايا، حيث نتظاهر بالجهل أو نتبنى الزيف، فقط لنُجبر العالم من حولنا على أن يكون أكثر وضوحاً ودقة.
ولا يتوقف هذا الاستدراج المعرفي عند حدود الأرصفة والمقاهي، بل يتسلل بذكاء إلى كواليس المؤسسات والشركات، حيث تصبح الحقيقة في كثير من الأحيان «عملة نادرة» لا تُمنح مجانًا في الاجتماعات الرسمية.
في بيئات العمل، يميل الموظفون والمدراء إلى التحفظ، ويغلفون المعلومات بستار من الدبلوماسية أو الصمت الحذر؛ وهنا يبرز «قانون كانينجهام» كأداة إدارية غير تقليدية لكسر هذا الجمود.
إن المدير الذكي، أو الزميل المحنك، قد لا يسأل: كيف سنسير في هذا المشروع؟، بل يطرح فرضية خاطئة أو خطة عمل مستفزة بضعفها، ليجبر الفريق على التخلي عن صمته.
في تلك اللحظة، يسقط قناع التحفظ، وينبري أصحاب الخبرة لتفنيد الخطأ وتقديم الحلول الحقيقية والبيانات الدقيقة التي كانوا يدخرونها لأنفسهم؛ ليس حبًا في المؤسسة فحسب، بل لأن خبرتهم المهنية تأبى أن تنهزم أمام طرح سطحي أو خاطئ.
هكذا يتحول «الخطأ العمدي» في العمل إلى «مسبار» لاستخراج الكفاءة، حيث تخرج أفضل الأفكار والحلول لا عبر العصف الذهني الهادئ، بل عبر غريزة الدفاع عن الصواب المهني التي تستفزها «الحماقة المُصطنعة».
في نهاية الأمر يبدو أن قانون كانينجهام هو «الترمومتر» الحقيقي لنبض الشارع. يخبرنا أننا نعيش في عصر لا يحركنا فيه الفضول بقدر ما يحركنا «الاستعلاء المعرفي».
الحقيقة المُرّة هي أننا قد نكذب لنعرف الصدق، وقد نخطئ لنصل إلى الصواب، في مفارقة ساخرة تجعل من الصمت في حضرة السؤال ذكاء، ومن النطق في حضرة الخطأ فخًا يقع فيه حتى أكثرنا تكتمًا.
لذا، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تسرع لتصحيح أحدهم، توقف قليلاً واسأل نفسك: هل أنت من يمنح المعلومة،
أم أنك مجرد ضحية أخرى لقانون كانينجهام؟